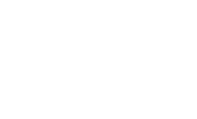بداية متفائلة لأسبوع «الهوت كوتير» الباريسي لربيع وصيف 2011

في الوقت الذي ستتجه فيه أنظار البعض، غدا، إلى متابعة «منتدى دافوس الاقتصادي العالمي»، وما سيتمخض عنه من نتائج قد تكون لها تأثيرات مباشرة على حياتنا، توجهت أنظار البعض الآخر، يوم أمس، إلى باريس لتكحل عيونها بأزياء قد لا تؤثر على مصيرنا لكنها حتما ستؤثر على أذواقنا وما سنلبسه في الموسم القادم. فحتى قبل أن تلتقط أوساط الموضة أنفاسها بعد عروض الأزياء الرجالية، انطلق في عاصمة النور والأناقة موسم الأزياء الراقية، المعروف بـ«الهوت كوتير».
ومرة أخرى، انطلقت معه النقاشات والجدل حول مدى جدوى هذه الأزياء وما إذا كانت تتماشى مع العصر، لا سيما مع تقلص نسبة زبوناتها وغلاء أسعارها وتغير ثقافتها. فالسوق الأميركية التي كانت تنعش هذا الجانب تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية وأصابت الكثير بحالة من الحذر، كما أن العصر ليس هو العصر، والمرأة التي لم تكن تعمل، وكانت تقضي أوقاتها في المجاملات الاجتماعية والحفلات الخيرية والخاصة، وبالتالي تحتاج إلى فساتين مفصلة على المقاس لا مثيل لها، انقرضت تقريبا وحلت محلها امرأة عصرية تنوء بتحمل مسؤوليات تجعلها تعيش ماراثونا حياتيا بشكل يومي تقريبا.
صحيح أنها تريد التميز، لكن الترف بالنسبة لها هو توفر الوقت، وبالتالي فإن فكرة السفر إلى باريس للقيام ببروفات وتغييرات على أي قطعة تطلبها، أمر يجعلها تعزف عن هذا الجانب إلا في حالات قليلة مثل حفلات الأعراس. حتى يكسب المصممون ود هذه المرأة، ابتكروا طرقا جديدة لإرضائها والحفاظ عليها، بالسفر إليها أينما كانت وكلما طلبت. بل إن بعضهم يقول إنها تفضل هذه الطريقة لأنها تمنحها السرية والغموض، مضيفين أن هذه الشريحة في تزايد مستمر بفضل دخول أسواق جديدة على الخط، خصوصا من آسيا والشرق الأوسط.
هذا يعني أنه يوجد مقابل كل ألف شخص يدين هذه الصناعة وتكاليفها وبذخها هناك امرأة واحدة ترحب بها ومستعدة لاقتنائها مهما كان الثمن ومهما كان حجمها وحجم سرياليتها وفانتازيتها، وهذا يكفي ويحفز. بالإضافة إلى هذا فإن معظم المصممين، إن لم نقل كلهم، يبررون شطحاتهم فيها، التي تثير الكثير من التساؤلات عن مدى عملية وواقعية ما يقدمونه من أزياء في هذا الموسم، على أنها مشروعة. فموسم «الهوت كوتير» لا علاقة له بالعملية، فهو الذي يتيح لهم التنفيس عن إمكانياتهم الفنية، عدا أنها المختبر الذي تولد فيه معظم اتجاهات الموضة التي تصل إلى شوارع الموضة العامة والعالمية في ما بعد.
فمثلا إذا ظهرت عارضة مغطاة بالورود من رأسها إلى أخمص قدميها، فإن هذا إشارة إلى أن هناك عطرا سيطل علينا في نفس الموسم بخلاصات هذه الورود، أو أن أزياءنا ستتلون بألوان السوسن أو القرنفل أو الياسمين، أو فقط هي إشارة إلى أي الألوان ستطغى على ظلال العيون أو أحمر الشفاه، وهكذا. أما المصاريف التي يتكلم عنها الجميع وتستفز البعض، فإنها تبقى لا شيء بالنسبة لامرأة تعرف أنها ستقتني قطعة لا تتكرر، وربما ستجد طريقها إلى متحف من المتاحف في المستقبل. ومع ذلك لا ينكر أن عدد هؤلاء الزبونات تقلص بكم كبير مقارنة بما كان عليه.
ولم يؤثر هذا التقلص على أرباحها فحسب، بل أيضا على أسبوع باريس الذي تقلصت مدته إلى 4 أيام بدلا من أسبوع، بينما وصل عدد المصممين المشاركين في برنامجه الرسمي حاليا إلى 11 مصمما، مقارنة به في عام 1987، مثلا، حيث كان عددهم 24 مشاركا. فالراحل إيف سان لوران أعلن مخاصمته للأسبوع وتقاعده في عام 2002، وإيمانويل أونغارو انسحب أيضا في عام 2004 متقاعدا، وفي 2009 فقد الموسم واحدا من أهم أبنائه، كريستيان لاكروا، لأسباب مادية بحتة، وهكذا. وربما هذا ما جعل الفيدرالية الفرنسية، شومبر سانديكال، تتدخل لتصحيح الوضع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بإضافة أسماء جديدة لبرنامجها الرسمي، وكان الحظ هذا العام من نصيب البرازيلي غوستاف لينز والفرنسي كريستوف جوس، بينما استضافت 3 فرنسيين آخرين هم: جوليان فورنييه (35 عاما)، الذي عمل كمصمم فني في دار «تورانت»، ومكسيم سيموانز (26 عاما)، الذي أسس داره الخاصة في 2008 وعمل سابقا مع جون بول جوتييه، «ديور»، و«بالنسياجا»، وألكسندر فوثييه (39 عاما)، وسبق له العمل مع كل من ثيري موغلر وجون بول غوتييه. وكانت الفيدرالية قد أضافت في السابق المغربية بشرى جرار، التي قدمت ثالث تشكيلة لها يوم أمس؛ تشكيلة أقرب إلى أزياء جاهزة راقية لكل المناسبات والأيام منها إلى «الكوتير» بمعناها الباهر أو الفانتازي، إذ لم يكن هناك ولو بريق حجر كريستال أو «ترتر». بشرى تصر إلى حد الآن على تقديم قطع هادئة تعكس قدرتها على فن التفصيل أولا وأخيرا.
قبل عرض بشرى جرار، كان الفرنسي أليكسيس مابيل، هو من افتتح الأسبوع في الصباح الباكر بتشكيلة هادئة، إلى حد الفتور، حاد بها عن المألوف، حيث استبدل بـ«الفيونكات» التي يعشقها، والفساتين التي يغلب عليها الأبيض والأسود، تصاميم هندسية لعبت فيها الألوان دورا مهما لتحديد معالم الجسم وخلق خدع بصرية. ومع ذلك لم تغب «الفيونكات» ووجدت طريقها إلى قطع معدودة جدا.
للمرة الثانية كان متحف «رودان» هو المسرح الذي اختارته «ديور» لعرض تشكيلتها لربيع وصيف 2011 مع فرق واضح وهو أن القاعة المنصوبة في حديقة المتحف كانت أكبر حجما لتحتوي نسبة أكبر من الحضور. فـ«ديور» التي تعيش انتعاشا ملموسا هذا العام، يتجلى في ارتفاع مبيعاتها في العام الماضي، وتحقيقها أرباحا رغم أنف الأزمة، ترجمت هذا الانتعاش في تشكيلة عادت بها إلى عصرها الذهبي، ألا وهو الخمسينات من القرن الماضي.
الحقبة التي كان فيها العالم يخرج أيضا من حالة تقشف، وقام فيها السيد كريستيان ديور من خلال ثورة «نيو لوك» المتميزة باستعمال أمتار وأمتار من الأقمشة المترفة. ثورته أثارت عليه البعض لكنها أغوت نساء العالم وأكسبته قلوبهن وما ملكت أياديهن، وسرعان ما انتشر الأسلوب المتميز بالجاكيت أو القميص المحدد عند الخصر ليبرز ضموره، والتنورة التي تتسع بشكل مثير لتنسدل فوق الركبة أو الأرض. جون غاليانو، مصمم الدار البريطاني الأصل، فعل نفس الشيء يوم أمس، وأتحفنا بتشكيلة شرحت بالأقمشة والألوان والخطوط ما معنى «الهوت كوتير»: إبهار وترف وأحلام تخاصم العادي وكميات سخية من التول والحرير. إذا كان هناك مأخذ على هذه التشكيلة فهو الألوان غير الساطعة والزاهية التي قد يرى البعض أنها لا تعكس أجواء الربيع والصيف، بيد أن هذا لا يعني أنها غير موفقة، بل العكس تماما، ولا شك أن غاليانو رأى أنها مهمة لخلق توازن مع تصاميمه المبالغ فيها أحيانا.
تصاميم لعب فيها كثيرا على الأحجام الضخمة، وعلى تقنية الأوريغامي التي يتقنها جيدا ويعود لها كثيرا في تشكيلاته الأخيرة. المصمم قال إنه استوحى ألوان وخطوط وحركة هذه التشكيلة من الفنان رينيه كريو، الذي تعاون مع الدار في مناسبات كثيرة، ونجح في التقاط روح «ديور» وأسلوبها في رسومات كثيرة، وهذا ما يفسر الفنية التي أسهب فيها المصمم، وكأنه يريد من خلالها الإشارة إلى أنه استعاد لياقة الأيام الخوالي عندما كان شابا جامحا يلتحق لأول مرة بدار فرنسية عريقة بهدف ضخ فيها دماء شابة.
فقد استعاد بعضا من هذا الجموح الذي روضته الأزمة المالية في المواسم الأخيرة، بدليل أنه لم يتوخ الحذر هذه المرة وإن كانت حركة معظم القطع وقدرتها على التمايل شفيعا لأحجامها الضخمة. لم تسلم أي قطعة تقريبا من هذه المبالغة، حتى التنورات المستقيمة مثلا نسقها مع جاكيتات بأكمام منفوخة وظهر يبدو وكأنه أخذ شكله من السلال التي تحملها اليابانيات أو العاملات في المزارع، بينما زين الفساتين الطويلة والمنسدلة إلى الركبة لتربط عندها، بالريش والورود المتمايلة مع كل نسمة وخطوة. بالنسبة للألوان، فقد لعب كثيرا على درجتين في القطعة الواحدة، تختلطان كما لو أن قنينة حبر سالت ورسمت خطوطا عليها، كما لم يغب اللون الرمادي، ماركة الدار المسجلة، وهو الأمر المتوقع منذ البداية بالنظر إلى السجاد الرمادي الذي بسط من مدخل متحف رودان إلى قاعة العرض، الذي ظهر في قفازات وأيضا في فستان طويل أنهى به المصمم عرضه، في إشارة إلى أنه يمكن أن يتحول إلى فستان زفاف بأي لون تفضله الزبونة.
لعب غاليانو أيضا على خلق خدع بصرية من خلال استعمال قماش التول كستار شفاف يغطي الحرير ويمنحه بعدا جديدا، لا سيما عندما يضفي عليه تطريزات وترصيعات لا يعلى عليها تؤكد أن أنامل ماهرة سهرت الليالي على إنجازها قبل أن تطل علينا، وقبل أن تصل إلى خزانة امرأة محظوظة. وأخيرا؛ نقول لغاليانو شكرا على الصنادل، فهي على الأقل تجمع الأناقة والأنوثة بشكل معقول مقارنة بالسنوات الماضية، كذلك المكياج الذي ابتعد عن الدراما المبالغ فيها كما عودنا. فهو على الأقل سيلهم المرأة العادية وسيجعلها تشعر بأن الدار لم تتجاهلها تماما، سواء كان كحلا أو أحمر شفاه أو ظلال عيون. فهو الوحيد الذي لن يكون حكرا على حفنة من الزبونات الثريات.