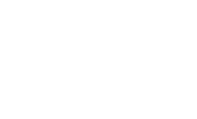معرض «بيتي أومو» .. ظاهرة نرجسية تتحول إلى تجارة ناجحة

عندما قال الفنان أندي وورهول في الستينات، إنه سيأتي يوم يصبح فيه أي واحد منا مشهورا ولو لـ15 دقيقة، لم يكن يتصور أحد أن هذه الجملة ستتحول إلى حقيقة وثقافة يجري العمل بها في عصرنا.
فإضافة إلى برامج الواقع التي غزت التلفزيونات وحولت كثيرا من الناس إلى نجوم يحققون الملايين من الأرباح، فإن الموضة أيضا أصبحت مسرحا لكل من يحلم بالشهرة ولو لدقائق، وهو أمر يؤكده معرض «بيتي أومو» الفلورنسي، إلى حد القول إنه من يُروج لهذه الثقافة التي خرجت من أصبحوا يعرفون بـ«الطواويس».
ما لا يختلف عليه اثنان أن فلورنسا واحدة من أجمل المدن في العالم. فكل شارع فيها يعبق بالفن، وفي كل ركن من أركانها تكتشف منحوتات أو رسمات يعود بعضها إلى القرون الوسطى، ولا تستغرب أيضًا أن تصادفك حفلة أوبرا في الهواء الطلق لم تكن في الحسبان. لهذا لا تخف من أن تضيع بين أزقتها وحواريها القديمة، لأنك ستكتشف بالصدفة، ساحات مخفية تكتنز تحفا ومفاجآت لم تكن تخطر على بالك.
لكن فلورنسا برهنت على مدى عقود، أنها ليست فنا فحسب، بل أيضا موضة، إلى حد أن سكانها يفخرون بأن الموضة الرجالية، بمفهومها الحالي، انطلقت من عندهم في الخمسينات من القرن الماضي ومهدت الطريق لتنظيم معرض «بيتي أومو» الذي يحتفل بدورته الـ91 هذا العام. صحيح أن غريمتهم، ميلانو دخلت على الخط بتخصيصها أسبوع موضة رجالي لا يستهان به، لا سيما وأن معظم المصممين المشاركين فيه معلنون كبار يفرضون وجودهم كما يفرضون على وسائل الإعلام حضوره، إلا أنها لم تنجح في سحب البساط من معرض «بيتي أومو».
فهذا الأخير يتمتع باستقلالية أكبر، ما أكسبه مكانة لم تهتز طوال سنواته. ولا شك أنه في هذه الدورة يعرف انتعاشا ملموسا تعززه التغييرات التي تشهدها أسابيع الموضة عموما، والموضة الرجالية خصوصا، فالقرار الذي اتخذته بيوت الأزياء، مثل «بيربري» و«جوتشي» وغيرهما بدمج عروضها النسائية والرجالية، يصب في صالحه.
ويرى المنظمون أنه يختلف في ثقافته وشخصيته عما تقدمه ميلانو ولندن وباريس للرجل، كونه عبارة عن معرض مفتوح يضم ما لا يقل عن 1200 ماركة عالمية تُعنى بكل ما يحتاجه الرجل من أساسيات وتفاصيل. وهذا ما يجعله مهما بالنسبة لصناع الموضة، من مبدعين ومصممين إلى تجار وأصحاب محلات وغيرهم، لكن شاء المنظمون أم أبوا، فهو يدين بشهرته العالمية أساسا لعشاق الموضة من الذين وجدوا فيه مسرحا مفتوحا يستعرضون فيه عشقهم هذا على الملأ، من دون قيد أو رقيب.
من هنا ولد مفهوم «الطواويس» و«نفش الريش» الذي يعني في لغة الموضة، رجالا يعانقون ألوان قوس قزح، وتصاميم محددة على الجسم، من دون أن يُقصروا في استعمال الإكسسوارات التي تُكمل مظهرهم وتزيد من جاذبيتهم، سواء تعلق الأمر بمنديل الجيب أو القبعات أو الأحذية المبتكرة التي تظهر بوضوح، نظرا لأن البنطلونات تكون في الغالب قصيرة أو مثنية. للوهلة الأولى، يعطون الانطباع، بأنهم مجرد طواويس ينفشون ريشهم في ساحة المعرض، حيث يتموضعون بشكل لافت وهم على أتم الاستعداد لالتقاط صور لهم، بيد أنهم في الحقيقة أفضل من يُترجم ما نراه على منصات العروض من جنون على أرض الواقع.
يأخذون ما يناسبهم ويطوعونه بأسلوب لا يخلو من الجرأة ليصبح على أيديهم مقبولا، بل ويمكن للرجل العادي أن يقتدي به إلى حد ما. لهذا ليس غريبا أن تتحول فلورنسا في شهري يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) من كل عام، إلى وجهة كل من يعشق الألوان ولفت الانتباه. فالموضة الرجالية تحديدا، باتت تحتاج إلى نظرة قادرة على التمييز بين الجنون والفنون، بعد أن أصبح الخيط بينهما رفيعا للغاية.
في الماضي كان عشاقها يحضرون أسابيعها ومعارضها لمتابعة ما سيجود به المصممون من إبداعات، أما الآن فقد أصبح كثير منهم يحضرونها للتسويق لأنفسهم واستعراض ما يلبسونه، سواء كان ما يلبسونه أنيقا يعطي ترجمة أوضح عن كيف يمكن تطويع ما نراه على منصات العرض، أو مجرد تقليعات غريبة تستجدي جلب الأنظار وحسب.
يدافع البعض بأن هذه الظاهرة، التي بتنا نراها سافرة في السنوات الأخيرة، ليست وليدة اليوم، وبأن جذورها مغروسة في ثمانينات القرن الماضي، حيث تزامنت مع صدور مجلات مثل «آي دي» التي تأسست على فكرة نشر صور أشخاص عاديين في الشوارع.
ظاهرة شجعها مصورون فوتوغرافيون لأنها خلقت لهم فرص عمل جديدة، لا سيما أن كثيرا منهم اكتشفوا أن التقاط صورة لأشخاص عاديين بأزياء، سواء كانت أنيقة أو غريبة، مُربحة أكثر من التقاط صور كائنات حية أو صور حرب وغيرها.
الفرق بين العملية في الماضي والحاضر، أنها كانت أكثر عفوية وغير تجارية. كان المصورون حينذاك يتصيدون وصول ضيفات أنيقات لا رغبة عندهن في جذب الأضواء، إلى حد أن بعضهن كن يتفاجأن ولا يفهمن سبب اهتمام المصورين بهن وبما يلبسنه، فيما كانت بعضهن تستنكرنه.
أما الآن، فأغلبية الضيوف، رجالا ونساء، يسعون إلى هذا الاهتمام بكل الوسائل. وحتى يعطوا الانطباع أن الصورة عفوية ولا يد لهم فيها، يتظاهرون إما بأنهم على هواتفهم النقالة، أو أنهم مشغولون بإرسال رسائل إلكترونية، بينما عيونهم تدور في كل الجوانب باحثة عن مواقع «الباباراتزي»، وكل جوارحهم تتمنى أن يستوقفهم أحدهم لالتقاط صورة يمكن أن تظهر على صفحات مجلة يقومون بنشرها على حسابهم في الـ«إنستغرام» مباشرة.
والدليل أنه بعد أن يلتقط المصور الصورة يتم تبادل بطاقات التعارف للتأكد من صحة الاسم عند نشره، والعنوان الذي سترسل إليه صفحة المجلة. تطور الأمر بالنسبة لمن لم يعد لهم صبر في البقاء تحت رحمة المصورين، فصاروا يتعاقدون مع مصورين خاصين يرافقونهم في هذه المناسبات لالتقاط صور احترافية ينشرونها في مواقعهم الخاصة أو يوزعونها على مواقع أخرى.
إذا كنت من الجيل القديم، فربما سينتابك شعور بالشفقة نحوهم وأنت تتابع هذا المنظر، لكن الحقيقة أنهم لا يحتاجون إلى هذه الشفقة، لأن الكثير منهم حولوا الاستعراض، أو بالأحرى هذه الاستماتة إلى لفت الأنظار، إلى مهنة يحصلون من ورائها على مبالغ طائلة. فهم الآن يحضرون هذه المناسبات في سيارات فخمة كما لو كانوا نجوما من الدرجة الأولى. الحديث هنا طبعا عمن أصبحوا يُعرفون بنجوم موضة الـ«ستريت ستايل» أو «الإنفلونسرز»، الذين تتسابق بيوت الأزياء على التعاون معهم لقاء مبالغ يحددونها.
لكن ليس كل المصممين لديهم القدرة على دفع مبالغ كبيرة لهم، وبالتالي فإن العملية تقتصر على هدايا تتمثل في أزياء يظهرون بها في هذه المناسبات، وينشروها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبالفعل، أكدت التجارب أن ظهورهم بقطعة مثيرة أو أنيقة، يمكن أن يكون له مفعول السحر، وأكثر تأثيرا من إعلان يصوره مخرج سينمائي محترف ويكلف الآلاف. لهذا من الطبيعي أن تتغير ديناميكية العملية وتفقد عفويتها لتخضع لحسابات تتطلبها السوق عموما والثقافة الحالية.
ثقافة تهلل للصورة وتشجع الكل على أن يصبح نجما ولو لدقائق، وهكذا تحول ما بدأ في الثمانينات كحركة ديناميكية وعفوية، تهتم بأشخاص عاديين يطوعون الموضة حسب أسلوبهم وحياتهم بغض النظر عن الماركة أو الأسعار، إلى حركة تجارية وتسويقية محضة، من خلال صور تكون أحيانا مفبركة أو مصورة باحترافية عن سابق قصد وترصد. ولم لا؟ فحتى أندي وورهول كان يؤمن بأن الغاية تبرر الوسيلة، والغاية هنا تعني عقود تجميل أو تعاونات مع بيوت أزياء عالمية بمبالغ خيالية، مثل كارولاين إيسا، التي ظهرت في حملة إعلانية لشركة «جي كرو» الأميركية في عام 2012 إلى جانب أخريات.
المدرسة القديمة، والمقصود هنا وسائل الإعلام الرصين وزبونات الجيل القديم، لا تزال تنظر إلى هذه الظاهرة على أنها مجرد سيرك تحركه الفوضى، ولا بد من تقنينه وترتيبه. لكن نجوم هذه الظاهرة يرون أن الزمن زمنهم، وعليهم اقتناص الفرص المتاحة أمامهم، وإلا فاتهم القطار وتركوا حصتهم لغيرهم. ما يشجعهم أن مجلات براقة كثيرة تقبلتهم، وباتت تخصص لهم عددا من صفحاتها، كما لم تعد تُطلق عليهم لقب «مدونين»، بل لقب «إنفلونسرز» Influencers، أي مؤثرين، وتطلب ودهم بتخصيص إما زوايا يدلون بدلوهم فيها عن الموضة، أو جلسات تصور أسلوبهم مع مقابلات عن حياتهم و«إنجازاتهم».
وهي بالفعل إنجازات بالنسبة لبعض المدونين المتخصصين، مثل سوزي لو، صاحبة مدونة «ستايل بابل»، التي تنال كثيرا من الاحترام لمهنيتها الصحافية، إلى حد أنها لم تعد تحتاج لالتقاط صور للتعريف بنفسها. الجميل فيها أنها استغلت شهرتها للتعريف بالمصممين الصاعدين، الذين تفضل أن تلبس تصاميمهم في المناسبات المهمة. نجاحها حفز كثيرات من بنات جيلها على تقليدها.
وعلى الرغم من أنها لا تخاف من مزج ألوان صارخة ونقشات متضاربة، فإن قوتها تكمن في كتابتها. مثلها باندورا سايكس، وهي مدونة ومتعاونة مع مجلة «ستايل» التابعة لـ«صنداي تايمز». فهي تتقن فن استعراض ما تلبسه بأناقة، كما أن لها أسلوبا صحافيا يفتقده كثير من هؤلاء «الإنفلونسرز» الذين يعتمدون على الصورة وحدها.
الآن قد تصل تغريدة واحدة إلى ملايين المتابعين، الأمر الذي يفسر أن سعرها قد يصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني، ويؤكد أن «نفش الريش» لم يعد عملا نرجسيا فحسب، بل مشروعا تجاريا ناجحا. لهذا يمكن القول إن وجود طواويس «بيتي أومو» في فلورنسا، وتموضعهم الاستراتيجي لجذب أنظار المصورين، ليس اعتباطا، بل وراءه أهداف وآمال كبيرة.