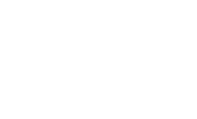موسم التخفيضات .. «فرانكشتاين» خلقته بيوت الأزياء ولا تعرف كيف تتخلص منه

عندما اجتاحت الأزمة الاقتصادية العالم في عام 2008. لم تؤثر على الشركات وصناع الموضة فحسب، بل أثرت على ثقافة السوق والتسوق ككل.
فمنذ ذلك الحين، والأسعار إما تزيد غلاء لتخاطب شريحة الأثرياء الذين باتوا يرفضون شراء منتجات تشاركهم فيها الطبقات الأقل منهم ثراء، أو تزيد رخصا لكي تخاطب الطبقات المتطلعة للموضة ولا تستطيع للمنتجات الغالية سبيلا، فيما أصبح يُشار إليه بالموضة السريعة حاليا.
وإذا كانت الشريحة الأولى تضم فئة قليلة جدا، يمكن تشبيهها بالنادي النخبوي الذي لا يدخله أي كان، ما يجعل المنافسة فيه محصورة على بعض البيوت والشركات الكبيرة، فإن الفئة الثانية تشمل الغالبية وبالتالي هي الأكثر تأثيرا على طريقة التسوق والتعامل مع الموضة عموما.
وغني عن القول: إنها الأكثر تأثيرا أيضا على بيوت الأزياء والشركات، لما تسبب لهم من أرق تشعر معه وكأنها خلقت «فرانكشتاين» أصبح من الصعب عليها كبح جماحه والتحكم فيه.
فكلما رخصوا الأسعار وزادوا من نسبة الإغراءات لجذب الزبون، كلما زاد هذا الأخير طمعا في المزيد.
يقول كيت يارو، وهو بروفسور في علم النفس من جامعة «جولدن جايت» أن «المستهلك تعود حاليا على التنزيلات الكبيرة وبات يتوقعها كتحصيل حاصل، إلى حد أن الكثير منهم يؤجلون شراء معطف شتوي هم في حاجة إليه، أو جهاز إلكتروني حتى آخر السنة، لأنهم يعرفون مسبقا أنهم سيحصلون على بُغيتهم بنصف السعر».
بدوره يؤكد طبيب علم النفس والأعصاب ديفيد لويس بأن التسوق في موسم التنزيلات له متعة تتعدى الناحية المادية إلى الناحية النفسية، شارحا أن معظم المتسوقين يشعرون بسعادة قصوى عندما يحصلون على «صيد أو غنيمة».
في البداية يدفعهم شعور بالخوف من تفويت فرصة ثمينة، تليه فرحة عارمة عندما يقع بين أيديهم منتج بثمن مخفض. ويوافقه الرأي ديمتريوس تريفريكوس، وهو خبير نفسي في جامعة لندن قائلا: «لقد أصبح هؤلاء أشبه بصيادين وجامعين .. يتصارعون على الأشياء.. يجولون في كل الزوايا بحثا عنها».
ولم ينس أن يشير إلى أن البعض يتصارعون بالأيادي ويتخاطفون على أشياء ربما هم ليسوا في حاجة ماسة إليها، لكن فكرة تفويت فرصة من هذا النوع تخيفهم وتوقظ الجانب الغريزي بداخلهم.
ويقوى إحساسهم بالخوف عندما يعرفون أن الوقت المتاح أمامهم للحصول عليها محدد. وهذا تحديدا ما حاولت الشركات الكبيرة استغلاله في البداية وأوقعها في مأزق يكلفها الكثير الآن.
فقد وقعت في الشرك الذي نصبته من تلقاء نفسها، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار السيكولوجية والغريزة البشرية.
بداية الأزمة، أو المأزق، بدأت في 2008 حين انتهجت الكثير من بيوت الأزياء والشركات سياسة تخفيض منتجاتها، وخلق مناسبات مثل «بلاك فرايداي»، «فوغ نايتس» وغيرها لتحريك السوق الراكدة.
لم ترق الفكرة لذوي الدخل المحدود فحسب، بل أيضا للأغنياء، الذين يتسابقون على «غنائم»، من باب «زيادة الخير خيرين».
ولا يستغرب خبراء علم النفس الأمر، بل يشرحونه بتأكيدهم بأنه بداخل كل واحد منا صياد يتلذذ بـ «غنيمة» فاخرة يحصل عليها وتُشعره بذكائه التجاري.
فمن منا لا تتسارع دقاته قلبه وهو يمسك بقطعة تم تخفيضها بنسبة 75 في المائة مثلا؟
أو يمسك بإكسسوار لم يكن يحلم به وأصبح فجأة ضمن إمكانياته؟ لا يختلف اثنان أنه من الصعب مقاومة ذلك الإحساس الذي يغمر كل الحواس ويجعلها متوثبة للمزيد، أو ذلك الصوت الملح الذي يقول إن هذا هو يوم الحظ الذي لا يمكن أن يتكرر وبالتالي من الواجب الاستفادة منه بكل الإمكانيات.
العلماء يردون هذا الإحساس إلى الناقلات العصبية التي تفرز مواد مثل السيروتونين والدوبامين، التي تثير مشاعر سعادة تشبه تلك التي يثيرها الأدرينالين في الجسم.
والنتيجة أن المستهلك أدمن على التخفيضات، إلى حد أنه مستعد أن يصبر وينتظر أشهرا إلى حين موسم التنزيلات لشراء قطعة أعجبته عوض شرائها مباشرة.
والطريف أن الأمر قد يشمل المحلات الشعبية أيضا، مثل «زارا» و«توب شوب» مثلا رغم أن أسعارها ليست غالية أساسا.
وهكذا تحول ما ولد كمضاد للأزمة الاقتصادية إلى أزمة تحتاج إلى عملية فطام ذكية.
من جهتها، لا تنكر الكثير من الشركات والمحلات بأنها في أزمة لا تعرف كيف تخرج منها بعد أن شهدت قيمة أسهمها انخفاضا بسبب تراجع مبيعاتها.
ما زاد في الطين بلة أن الإقبال الذي تشهده في «بلاك فرايداي» أو خلال موسم التنزيلات لا يعوضها عما تخسره.
فمهما زادت عملية البيع في هذه الأوقات، فإن الأرباح لا تزيد لا سيما أن المنافسة كبيرة بين المحلات.
فعندما يُخفض محلا منافسا منتجاته بنسبة 20 في المائة أو 30 في المائة، في الأيام العادية مثلا، فإن المحل المجاور أو المقابل له، لا يجد بدا من أن يحذو حذوه.
وهذا تحديدا ما يزعج الشركات، التي تعرف بأنه في حال طالت العملية فإن الفرق بين سعر الإنتاج وسعر الشراء سيؤثر على استمراريتها.
البعض الآخر يحاول حل هذه المعضلة بأساليب أخرى، مثل تقديم محفزات تتمثل في توقيع اسم الزبون على المنتج أو طرح منتجات محدودة بنقشات وألوان فنية يمكن شراؤها للاقتناء، للزيادة من قيمتها ومن ثم رغبته فيها.
وينطبق الأمر هنا على مستحضرات التجميل والعطور كما على الإكسسوارات مثل الأوشحة أو الساعات.
بيد أن الزبون أصبح ذكيا ومتمرسا في لعبة أصبح هو المستفيد منها.
فهو يحفظ الآن تاريخ «بلاك فرايد» عن ظهر قلب، ويترقب موسم التنزيلات وكأنه حقه الشرعي، غير عابئ بتبعات كل هذا على حركة البيع في الأيام الأخرى.
مواقع التسوق الإلكترونية لعبت دورا مهما في منح هذه الثقافة الاستهلاكية الجديدة دفعة غير مسبوقة، إذ أن بعضها يقدم تنزيلات طوال الوقت، مثل موقع «أمازون» بالإضافة إلى أسواق التجزئة المترامية خارج المدن الكبيرة.
فهذه تقدم منتجات مخفضة طوال السنة، ما يجعل المحلات الأخرى في سباق دائم معها لجذب الزبائن، من خلال تقديم تنازلات إضافية. البيوت التي نجت من هذه الأزمة قليلة، نذكر منها «هيرميس» و«لويس فويتون»، لأنها اتبعت استراتيجيات مختلفة تماما.
«لويس فويتون» ترفض فكرة التنزيلات رفضا باتا منذ البداية، ولا تعتبرها عادلة أو مربحة.
صاحبها الملياردير الفرنسي، برنار أرنو شرح وجهة نظره في إحدى المقابلات قائلا بأنه من الظلم أن يشتري زبون حقيبة بسعر كامل، فقط ليحصل عليها زبون آخر بعد بضعة أشهر أو أسابيع، بنصف الثمن.
الأمر بالنسبة له ليس في صالح أي أحد، وكان على حق. مؤخرا أعلنت «جوتشي» أنها هي الأخرى ستتبع نفس الاستراتيجية بعد أن صرح رئيسها التنفيذي، ماركو بيزاري أن التشكيلتين اللتين صممهما مديرها الفني الجديد أليساندرو ميكيل هذا العام لن يخضعا للتخفيض للمحافظة على قيمتهما من جهة، ولأنهما يستحقان ثمنهما الأصلي من جهة ثانية.
لكن إذا كانت المجموعات المالكة لبيوت مثل «هيرميس»، «جوتشي»، «لويس فويتون» وغيرها قادرة على هذه المجازفة، فإن بيوتا أخرى لا تملك هذا الترف، لأنه ليس لديها ما يُسندها ويُعوضها عن الخسارة التي يمكن أن يسببها رفضها تنزيل منتجاتها والتخلص منها بأي ثمن حتى لا تبور، ليبقى التفكير في حل يرضي كل الأطراف مفتوحا، رغم أن الأمل ضعيف في الوقت الحالي بالنظر إلى أن شهية المستهلك مفتوحة على كل ما هو مخفض وفاخر.