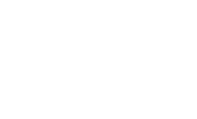" رغم إنها أغنى سنة في تاريخ البشرية " .. مليارديرات العرب أغنياء لكن أشّحاء

إنها أغنى سنة في تاريخ البشرية" .. هكذا علقت مجلة (فوربس) على القائمة السنوية التي تصدرها لأعضاء نادي المليارديرات في العالم، وبالتأكيد لم تكن هناك أي مبالغة في هذا الوصف؛ فأعضاء القائمة البالغ عددهم (946) مليارديراً نجحوا خلال العام الماضي فقط في إضافة (900) مليار دولار إلى ثرواتهم لتبلغ (3.5) تريليون دولار، بارتفاع قدره 19% عن العام السابق، ومن اللافت في قائمة هذا العام أن الأثرياء العرب لم يكونوا بعيدين عن هذه الطفرة؛ إذ سجلت قائمة هذا العام دخول (8) مليارديرات جدد، مما رفع عدد الأعضاء العرب في قائمة أثرياء العالم إلى (33) شخصاً، من بينهم (11) مليارديراً سعودياً.
ويبدو أن عام 2006 كان "عاماً مفترجاً" على مليارديرات العالم؛ إذ نجحوا في رفع ثرواتهم من (107.2) مليار دولار إلى (179.7) مليار دولار، وهو ما يتجاوز موازنات (15) دولة عربية مجتمعة من غير الدول النفطية ومصر. لكن هذه الصورة " المضيئة" لها وجه مظلم، حيث جاءت (8) دول عربية إسلامية في ذيل المؤشر العالمي للجوع عام 2006، كما كشفت الإحصائية؛ التي أعدتها منظمة "الفاو" ـ التابعة للأمم المتحدة ـ أن 13% من سكان العالم العربي يعانون من سوء التغذية؛ أي ما يعادل (39) مليون شخص.
وبالطبع فإن الفقر هو الوجه الآخر للبطالة، ولهذا لم يكن مستغرباً أن 20% من قوة العمل العربية البالغة (113) مليون نسمة يعانون من البطالة، فيما يُتوقع أن يصل عدد العاطلين إلى نحو (60) مليون عاطل بعد (10) سنوات، وفقاً لتقديرات مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. وهنا يُطرح السؤال الذي يحيّر الكثيرين.. كيف يزداد أثرياء العرب ثراء فيما يزداد الفقراء فقراً؟، بل يتمدد خط الفقر من عام لآخر؛ ليضمَّ ملايين العرب تحته، كما ينضم مئات الآلاف من الشباب سنوياً لطابور البطالة؛ ليشكلوا قنبلة موقوتة تنذر بالانفجار في وجه مجتمعهم في أي لحظة.
وبوضوح أكثر فإن قائمة "فوربس" السنوية بما تتضمنه من مليارديرات عرب تطرح علامة استفهام تتضخم من عام لآخر حول: الدور الاجتماعي لأثرياء العرب، وأين حق المجتمع في هذه الثروات؟ وهل هناك التزام لا تفرضه القوانين، ويتجاوز ما تقرره الأديان يجب على هؤلاء الأثرياء مراعاته؟.. التزام ينبع من تقاسم الأثرياء والفقراء الإيمان بأنهم يصنعون مستقبلاً مشتركاً، لدولهم وأمتهم، ولا إمكانية لبقاء أحدهما بدون وجود الآخر. .
عائلات الثروة
وقبل الشروع في محاولة الإجابة عن الأسئلة السابقة، ربّما يكون من المهم إلقاء الضوء على أبرز المؤشرات؛ التي تضمنتها القائمة الجديدة لـ(فوربس)، بخاصة بالنسبة للأثرياء العرب، إذ مازالت "عائلات الثروة" تقدم المزيد من المليارديرات الجدد؛ ففي السعودية قدمت عائلة الراجحي أربعة مليارديرات، ومثلهم لعائلة ساو يرس في مصر، وكذلك الأمر بالنسبة لعائلة الحريري في لبنان، كما ضمت القائمة الأخوين نجيب وطه ميقاتي من لبنان، إضافة إلى اثنين من عائلة "الفطيم" الإماراتية، ومثلهم لعائلة "الغانم" الإماراتية أيضاً.
وبالنسبة لتوزيع المليارديرات على الدول العربية، فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى ممثلة بـ 11 مليارديراً بثروة إجمالية بلغت (44.2 مليار دولار) ، وجاءت لبنان في المركز الثاني بستة مليارديرات، تليها الكويت (16.1 مليار دولار)، الإمارات (16 مليار دولار)، ومصر (20.4 مليار دولار)، ولكلٍ منها 4 مليارديرات.
وكان من اللافت في قائمة هذا العام، استمرار تراجع مركز الأمير الوليد بن طلال وخروجه من قائمة أغنى (10) أشخاص في العالم، محتلاً المركز الثالث عشر، على الرغم من أن ثروته ارتفعت بنحو (300) مليون دولار لتبلغ (20.3) مليار دولار. بينما نجح المصري نجيب ساويرس في القفز من المرتبة (278) إلى المركز (62) بعدما ارتفعت ثروته من 2.6 مليار دولار إلى (10) مليارات دولار العام الماضي، كما قفز رجل المال السعودي سليمان بن عبد الله الراجحي؛ الذي استطاع زيادة ثروته من (5.6) مليار دولار إلى (11) مليار دولار، من المركز (80) إلى المركز(37) .
أما فيما يتعلق بالمؤشرات العامة لقائمة "فوربس" لهذا العام، فقد كان لافتاً انضمام المزيد من الروس (53 مليارديراً)، والصينيين، والهنود (36 مليارديرًا)للقائمة، كما شهدت القائمة انضمام العديد من العاملين بقطاعات أسواق الأسهم، والعقارات، وتجارة السلع حول العالم.
ولم يطرأ تغيير على المراكز الخمسة الأولى بالقائمة، حيث احتفظ بيل جيتس -مؤسس شركة مايكروسوفت العملاقة للبرمجيات- بالصدارة للعام الـ (13) على التوالي، بثروة بلغت (56) مليار دولار، بزيادة ستة مليارات عن العام الماضي، كما جاء الأمريكي وارن بافت -رئيس صندوق بركشاير هاواي للاستثمار- في المركز الثاني بثروة قُدّرت بنحو (52) مليار دولار بزيادة عشرة مليارات عن العام 2006.
وحل قطب الاتصالات المكسيكي -اللبناني الأصل- كارلوس سليم حلو، في المركز الثالث بـ (49) مليار دولار بعدما تمكن من إضافة (19) مليار دولار إلى ثروته العام الماضي، ولا تزال عائلة كامبراد السويدية في المركز الرابع بثروة قدرها (33) مليار دولار، يليها في المركز الخامس رجل الأعمال الهندي لاكشمي ميتال بثروة بلغت (32) مليار دولار.
مؤشرات متضاربة
ربما تكون المفارقة الأولى التي يمكن ملاحظتها عند مقارنة المؤشرات العامة لقائمة (فوربس) بمؤشرات العضوية العربية فقط، هي: أن تزايد عدد الأعضاء الروس والصينيين والهنود بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي يبدو منطقياً في ظل تزايد مؤشرات النمو الإجمالية في هذه الدول، ونجاحها في تحقيق قفزات اقتصادية رفعت من مستوى معيشة مواطنيها، وعلى العكس من ذلك فإن تزايد عدد المليارديرات العرب يأتي متناقضاً مع تزايد معدلات الفقر والبطالة في دولهم، ولعل ذلك ما يفسر شكوى معظم المواطنين العرب من عدم إحساسهم بمردود نسب النمو الإجمالية التي تعلنها حكوماتهم، فعدم التوازن في توزيع الثروة يجعل معدلات النمو تنعكس فقط في ازدياد ثروات الأغنياء بينما يزداد الفقراء فقراً.
ومع أن هذا الاختلال في توزيع الثروات قد ألقى بظلاله على المجتمعات الغربية لسنوات طويلة؛ إلاّ أن الدور الاجتماعي الفعال للعديد من المليارديرات الأوروبيين والأمريكيين قد خفف كثيراً من وطأة هذا التفاوت الرهيب على الفقراء ومحدودي الدخل في بلدانهم، وهنا تبرز إجابة وارن بافيت، الذي حل ثانياً في قائمة هذا العام عندما سُئل عما إذا كان من الأجدر أن يترك ثروته لأبنائه وأفراد عائلته، فرد قائلاً: "أعتقد أنه عندما يكون لك أبناء لديهم كل الامتيازات من تربية جيدة وتعليم ممتاز وفرص أخرى كثيرة فإن إغراقهم فوق ذلك بالأموال ليس بالأمر الحكيم، أو المفيد بالنسبة لهم". كما لم يكن بيل جيتس الرجل الأغنى في العالم بعيداً عن هذا المنطق، حيث اعتبر أنه من واجب أصحاب المليارات أن يجعلوا ثرواتهم في خدمة المجتمع، داعياً "الجميع إلى التحلي بروح الإحسان".
حق المجتمع
إجابة وارن بافيت وتصريحات جيتس، تمثل الفارق بين الأثرياء الغربيين ونظرائهم العرب؛ فالرأسمالية الغربية وبعد عقود طويلة من امتصاص عرق الفقراء واستعبادهم بدأت تقلم أظافرها بنفسها؛ كي ترتدي ثوباً أكثر إنسانية، لعل ذلك يخفف من الطابع المادي الصارخ للمجتمعات الغربية، بينما تبدو هذه الإنسانية صفة لصيقة بالتعاليم الإسلامية؛ فالشرع يبيح للإنسان التصرف في ثلث ثروته على ألاّ يكون للورثة الشرعيين نصيب فيه، كما يحث القرآن الكريم على إعطاء الفقراء والمساكين؛ الذين يحضرون توزيع التركة نصيباً منها.
هذه التعاليم الإسلامية هي بالضبط ما ينفذه أثرياء الغرب، ولتكن البداية مع بيل جيتس، فالرجل الذي جمع ثروته بعصامية وبدأ من الصفر، تحول في السنوات الأخيرة إلى أحد أكبر المتبرعين للأعمال الخيرية والإنسانية في العالم، وذلك عبر مؤسسة (بيل وميليندا جيتس)، التي أسسها مع زوجته في عام 2000؛ بهدف "تقليل التفاوت الهائل بين مستوى المعيشة التي نحياها ومستوى معيشة الناس في العالم النامي".
مؤسسة (بيل وميليندا جيتس)، والتي وصلت قيمة أصولها لنحو (27) مليار دولار، تمتد أعمالها عبر أكثر من مائة دولة، وقد بلغت قيمة المنح التي قدمتها منذ 1994 نحو (7.1) مليار دولار، وتتبع المؤسسة نهجاً عملياً مستوحًى من أسلوب عمل شركة "مايكروسوفت" للبرمجيات.
وتركز المؤسسة بشكل كبير على مكافحة الأمراض المستوطنة في الدول النامية؛ إذ تعهدت في فبراير الماضي بتقديم (83) مليون دولار؛ للمساعدة في مكافحة مرض السل، كما تبرعت العام الماضي بـ(168) مليون دولار؛ لتمويل بحوث مكافحة الملاريا، ووفّرت (60) مليوناً؛ لتمويل بحوث خفض مخاطر العدوى بالفيروس المسبب للإيدز بين النساء في بلدان العالم النامي.
ولم ينسَ جيتس فقراء الولايات المتحدة؛ إذ خصصت مؤسسته الخيرية منحة بقيمة مليار دولار، لصندوق جامعة نيجرو المتحدة، وهي أكبر منظمة لمساعدة الأقليات على الوصول إلى التعليم العالي في الولايات المتحدة، كما تساعد المؤسسة في إيصال التكنولوجيا إلى المكتبات العامة، وتموِّل المنظمات التي تعمل على تحسين حياة الأفراد في شمال غربي الولايات المتحدة.
بافيت الأروع
ما فعله بيل جيتس على روعته، يبدو متواضعاً تجاه الفلسفة التي يتبناها وصيفه في قائمة (فوربس) الملياردير وارن بافيت، فالملياردير الذي لا يزال يقطن نفس المنزل الذي اشتراه عندما تزوج منذ خمسين عاماً، ويقود سيارته بنفسه ولا يمتلك هاتفاً محمولاً، ولا تراه محاطاً بحراس شخصيين، قرر فجأة التبرع بـ(31) مليار دولار من ثروته للأعمال الخيرية في أضخم عملية تبرع لأعمال خيرية يشهدها التاريخ البشري، وليس هذا فقط، بل إنه تبرع بالمبلغ لمؤسسة (بيل وميليندا جيتس) الخيرية، ولم يلجأ لإنشاء منظمة خيرية خاصة تخلد اسمه، كما يفعل أقرانه من أمثال جيتس وروكفلر وفورد.
قرار بافيت غير المسبوق، يبدو متسقاً مع الفلسفة التي يتبناها، فهو يعتبر أنه: "بعد خمسين عاماً من الآن لن يكون مهما نوعية السيارة التي تركبها، ولا فخامة المنزل الذي تسكنه.. ولكن المهم والأهم هو نوعية تربيتك لأطفالك"، وهذه الفلسفة نفسها هي التي دفعته لمعارضة قرار الكونجرس بخفض الضرائب المفروضة على الثروات التي تؤول إلى مالكين جدد بطريق الإرث.
وتعكس الفلسفة الإنسانية لـ (راون بافيت) التزامه الاجتماعي العميق تجاه الفقراء والمحرومين، وهو ما عبر عنه قائلاً : إن الثروات الطائلة التي يتدفق جانب ضخم منها من جيوب أفراد المجتمع إلى خزائن الأثرياء يجب أن يتدفق جانب ضخم منها أيضاً في الاتجاه المعاكس لصالح المجتمع".
وبالإضافة إلى جيتس وبافيت، فإن الملياردير المكسيكي كارلوس سليم، الذي حل ثالثاً في قائمة فوربس، نشط في السنوات الأخيرة في عدة مجالات خيرية، لا سيّما في مجال مساعدة الأشخاص الذين يخرجون من السجن على الانخراط في المجتمع، وقد انطلق في مشروع كبير؛ لترميم وسط مكسيكو التاريخي.
والتبرع بالمال بهذا الشكل في الغرب ليس جديداً، فقد خصص أغنياء العالم في بداية القرن الماضي أمثال روكفلر وكارنيجي وفورد، جانباً كبيراً من ثرواتهم لإنشاء مؤسسات خيرية كبرى مازالت تبذل المال والدعم؛ لمساعدة الفقراء والمحتاجين والطلاب والمرضى وبناء المراكز الصحية والتعليمية والاجتماعية المختلفة، كما يبرز في هذا المجال، مؤسس جائزة نوبل الشهيرة السويدي الفريد نوبل، والذي أوصى بوضع القسم الأكبر من ثروته لخدمة العلم والعلماء والإنسانية في جوائز سنوية؛ تحمل اسمه تُمنح للبارزين في العلم والأدب وخدمة السلام العالمي في العالم أجمع بغض النظر عن الدين، أو الجنس، أو العرق، كما تبرّع رجل الإعلام الأمريكي الشهير تيد تيرنر مؤسس شبكة CNN)) قبل عدة سنوات بمليار دولار؛ لدعم الأمم المتحدة.
للعرب نظرية مختلفة
وتبدو أهمية دور المؤسسات الخيرية التي يدعمها رجال أعمال من ذوي "الوزن الملياري" في قدرتها على إدارة عمل خيري إنمائي طويل المدى، فيما لا تتجاوز قدرات المؤسسة الخيرية الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر النمط الأكثر شيوعاً عربياً وإسلامياً، العمل الإغاثي الطارئ وبشكل خاص في الأزمات الإنسانية والكوارث، كما أن نشاطها يُعتبر ذا طابع موسمي، سواء في الإنفاق أو التمويل.
وبشكل عام تخلو الدول العربية من وجود منظمات خيرية يمكن وصفها بالكبيرة، فأقصى ميزانية سنوية لجمعية خيرية عربية لا تصل بأي حال من الأحوال لرقم (500 مليون دولار) ، بل إنه وباستثناء المؤسسة الخيرية التي أنشأها رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري، فإن نشاط الجمعيات الخيرية العربية يبدو أبعد ما يكون عن النشاط الإنمائي الذي يُستثمر في صنع مستقبل أفضل للأجيال القادمة؛ فمؤسسة الحريري يُحسب لها التكفل بنفقات تعليم عشرات الآلاف من اللبنانيين في مختلف مراحل التعليم، منهم من حصل على الدكتوراة والماجستير من جامعات أوروبية وأمريكية بكفالة تامة من المؤسسة.
ويلفت ناشطون عرب في مجال العمل الخيري النظر إلى أن الأثرياء من ذوي الثروات الصغيرة والمتوسطة، يشكلون الدعامة الرئيسة لشبكة العمل الخيري والإغاثي في الدول العربية؛ فالعطاء الاجتماعي لهؤلاء يُعد هو الأكبر والأهم مقارنة بحجم ثرواتهم إذا ما قيست بثروات أعضاء نادي المليارات وما يقدمونه من تبرعات خيرية. لكن هذا العطاء وعلى الرغم من تشعبه وسخائه يبقى مفتقداً للطابع المؤسسي الإنمائي، كما أنه يبقى مرتبطاً بالتصرف الفردي لصاحبه، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تبرعات هؤلاء والجهات المستفيدة منها تبقى دوماً عصية على الإحصاء والدراسة؛ نتيجة قناعات أصحابها الدينية، فمْن مثلاً يصدق أن المساهمات السنوية للعطاء المحلي في مصر، سواء أكان عطاء مادياً، أو عينياً، أو تطوّعياً قد بلغت حوالي (950) مليون دولار.
وبالتأكيد هناك تبرعات وأنشطة خيرية لمعظم أعضاء نادي المليارديرات العرب، إلاّ أن هذه التبرعات والأنشطة تُعد محدودة وضئيلة مقارنة بحجم ثرواتهم، بخاصة إذا ما قورنت بما يقدمه نظرائهم في الغرب، كما أن هذه الأنشطة يعيبها الطابع الدعائي الذي يحيط بها، فضلاً عن افتقادها للطابع المؤسسي الإنمائي.