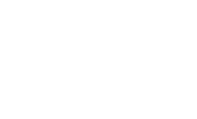أمينة متحف الفنون الزخرفية "باميلا جولبين" : وظيفتي أشبه بشرطي سري أو صحافي ميداني
11:05 ص - الثلاثاء 4 مارس 2014

باميلا جولبين .. تصدت للعقليات التقليدية وفتحت أبواب المتاحف للموضة والشباب
هناك صورة نمطية مرسومة في الذهن عن أمناء المتاحف عموما. فهم إما من الجنس الخشن، وإما مخضرمين تعدوا سن الشباب بسنوات، إن لم نقل بعقود.
لهذا، عندما وصلت باميلا غولبين، أمينة متحف متحف للفنون الزخرفية والأنسجة، إلى مقهى «الباليه دو لوفر» حيث كان موعد اللقاء، كانت المفاجأة غير متوقعة.
عندما اعترفت لها بما كان يجول بذهني قبل وصولها، ضحكت وقالت: «أواجه هذا كثيرا، فعندما بدأت العمل في المتحف منذ أكثر من 20 سنة، قالت لي زميلة فرنسية: (تذكري أن تأتي إلى العمل غدا ببنطلون). أدهشني قولها، لأني كنت شابة متحمسة ولم أفكر من قبل في أن هناك فرقا بين الرجل والمرأة في العمل، لا سيما أني تربيت في وسط عائلي مؤلف من ثلاث بنات، ولم نول هذا الجانب اهتماما. سألت حينها زميلتي بعفوية: (هل البنطلون سيجعلني رجلا أو يغير من حقيقتي؟!)». وتابعت وابتسامتها تزيد اتساعا: «عشت الموقف نفسه تقريبا، عندما ذهبت إلى أبوظبي منذ سنوات، فقد شعرت بأني مختلفة عن الباقين، ليس لأن كل من بالقاعة كانوا رجالا، بل لأن الكل كان يلبس اللون الأبيض. في تلك اللحظة فقط، انتبهت إلى أني المرأة الوحيدة في قاعة الاجتماعات».
لم تكن ملامحها تشي بعمرها الحقيقي، لكن بعملية حسابية سريعة تكونت لدي فكرة بأنها في الأربعينات.
فقد تخرجت في جامعة كولومبيا وهي في العشرينات من العمر، والتحقت بالعمل في المتحف في عام 1993؛ أي منذ 21 سنة تقريبا.
وسواء كانت في بداية الأربعينات أو منتصفها، فإنها أصغر أمينة متحف عرفتها فرنسا.
تتحكم في 15.000 قدم مربع من مساحة «الباليه دو لوفر»، وكانت - ولا تزال - القوة وراء ولادة معارض موضة مهمة، لم يكن من الممكن دخولها المتحف لولا عزيمتها وإصرارها على التحدي والتصدي للعقليات التقليدية التي لم تكن ترى أن الموضة يمكن أن تدخل المتاحف.
لحسن حظها، نجحت التجربة وتستقطب حاليا مئات الآلاف من الزوار سنويا.
تتذكر باميلا البدايات، وهي تلمح بأن دخولها هذا المجال لم يكن محفوفا بالورود، «لأن الموضة متخصصة، لها ناسها. وكان من هم خارج الوسط ينظرون إليها بنوع من الفوقية وعلى أنها سطحية. كانوا يتجاهلون أنها صناعة مهمة تتضمن الكثير من الرقي والفن، فضلا عن توظيفها الملايين من الناس في العالم، ومن ثم تدر المليارات على الاقتصاد العالمي. نعم، قد تبدو ظاهريا مترفة أو حتى سطحية، لكنها في الأساس جد مهمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. للأسف، كان هذا الرأي هو الرائج في المتحف من 20 سنة، ما شفع لي أنهم اقتنعوا مع الوقت بجدواها، وإن على مضض».
الاستراتيجية التي اتبعتها باميلا لإسكاتهم، اعتمدت على دمج الموضة بالدعايات، مستفيدة من الانتعاش الذي بدأت تشهده مجالات الفنون الزخرفية والتصميم عموما في تلك الفترة.
وتدافع عن استعمالها الجانب الربحي في مجال الفنون بقولها: «خذي الرسم والنحت مثلا، فما من شك أنهما مهمان، لكن هذا لم يمنع أن يكون لهما جانب صناعي، حتى في عصر النهضة. ففي تلك الحقبة، كانت هناك ورشات تنتج مئات الأعمال الفنية لبيعها في الأسواق، وهذا يدل على أنها كانت صناعة تتمتع بجانب تجاري لم يؤثر على جانب الإبداع».
عندما أعلق على أن المقاومة التي واجهتها في البداية قد يكون سببها أنها لم تولد في فرنسا، والكل يعرف مدى تعصب الفرنسيين لأي شيء يمس مؤسساتهم الثقافية أو يقتحمها، تجيب مصححة بسرعة: «صحيح أني لم أولد في فرنسا، لكني فرنسية بحكم أن والدي فرنسي. كون والدتي تشيلية، وأنا ولدت في البيرو، وتربيت ودرست في الولايات المتحدة الأميركية ثم أوروبا، مما يجعلني مزيجا من عدة ثقافات».
في طفولتها، لم تكن تتوقع أبدا أن تعمل في أي مجال فني، فقد كانت مهووسة بالرياضيات، «تعلمت الحساب وجداول الضرب وفك ألغاز الأرقام والعمليات الحسابية المعقدة وعمري لم يتعد الثلاث سنوات. فوالدي كان مهندسا، وكان دائما يدفعني لبذل المزيد من الجهد من أجل التعلم والتفوق. ولا أعرف كيف تطورت الأمور لأجد نفسي أدرس تاريخ الفن في جامعة كولومبيا». تتابع ضاحكة: «ربما يكون تأثير والدتي أكبر، فقد كانت مصممة ديكور».
التغيير حصل بالتدريج إلى حد أنها لم تشعر به.
فقد كانت تقضي معظم إجازاتها الصيفية في باريس مع جدتها لوالدها، التي كان يحلو لها أن تصحب حفيدتها لزيارة المعارض المختلفة. ورغم أن عمرها لم يكن يتعدى الست سنوات، فإن باميلا تتذكر معرضا كان في «متحف» عن أزياء القرن الثامن عشر، انبهرت به، وتعترف بأنه زرع بذرة لا شعورية لما تقوم به الآن.
عندما بلغت الـ 18 من عمرها، لاحظت الجدة أن حفيدتها تقضي الكثير من الوقت في السفر مع صديقاتها في الإجازات الصيفية، لذا نصحتها بأن تجد عملا مفيدا تكتسب منه بعض الخبرة. لم تمانع باميلا الفكرة، وبمساعدة جدتها التي كانت تتمتع بعلاقات واسعة، حصلت على دورة تدريبية في المتحف، قبل أن تعود إلى نيويورك لإكمال دراستها في جامعة كولومبيا.
تعلق باميلا: «كان من المفترض أن أعمل في دار (إيف سان لوران). وبالفعل، توجهت لإجراء مقابلة مع المسؤولين فيها، انتهت باقتراحهم علي أن أتقدم للعمل في المتحف. كان ذلك في عام 1989». في البداية، كان عملها في المتحف كمتدربة لإرضاء أهلها واكتساب بعض الخبرة، لكنها بعد أن تخرجت والتحقت بالمتحف في عام 1993، أدركت بحسها أن الفرصة أمامها كبيرة لكي تسجل بصمتها. فقد كان المتحف يفتح صفحة جديدة مع الموضة. بمعنى آخر، كانت التجربة بمثابة كانفس يمكن أن ترسم عليه بأي لون وتصوغه بأي شكل، مما جعل التحدي كبيرا ومثيرا في الوقت ذاته.
كان التحدي الأكبر أن تغير نظرة الناس إلى معارض الموضة، التي كانت زيارتها تقتصر على فئة معينة، ولم تكن بنفس الشعبية التي تتمتع بها الآن، الأمر الذي عملت على تغييره.
تتذكر هذه الفترة وتقول إنها محظوظة لأنها كانت في المكان المناسب وفي الوقت المناسب، «ففي عام 1992، تقرر تخصيص الجناح الروماني من متحف متحف للفنون الزخرفية، وهو جناح بمساحة تقدر بـ15.000 قدم مربع لإقامة معارض مخصصة للموضة والأنسجة. فهمت بسرعة أن الفرصة هائلة، وعلي أن أستغلها بشكل إيجابي».
بالفعل، لم تتهاون وأمسكت زمام الأمور بيد حديدية رغم صغر سنها، وقررت تنظيم معرضين في السنة على الأقل حتى تكون النتيجة في المستوى.
فكل معرض يتطلب الكثير من العمل الجاد، بكل ما يتضمنه من أبحاث طويلة ومحادثات مع المصممين أو المسؤولين.
نقطة الانطلاق لتنظيم أي معرض، أن تمحو من ذهنها كل الأفكار المسبقة عن المصمم أو الموضوع، والبدء من الصفر. لهذا، ليس غريبا أن يستغرق تنظيم بعض المعارض من ثلاث إلى خمس سنوات أحيانا.
ويعتمد اختيارها الموضوع أو المصمم على عدة عناصر؛ منها المساحة والتوقيت، فضلا عن مدى توافر القطع التي سيجري عرضها والمعلومات.
المعرض الذي نظمته عن المصممة مادلين فيونيه، مثلا، فرض نفسه عليها، بعد أن اكتشفت أن متحف يضم أكبر أرشيف لها في العالم، ومع ذلك لم تتخذ قرارا متسرعا، بل استغرق التفكير فيه سنوات.
فقد كان لا بد من إيجاد ممول، وعندما وفقت إليه، كان شرطه الوحيد أن يقام في تاريخ محدد.
الأمر نفسه حصل بالنسبة للمعرض الخاص بالمصمم فالنتينو، «من أجل تحقيقه، عملنا من قرب مع المصمم لفترة طويلة، وتابعنا مسيرته طوال 50 سنة. وكان مهما أن يتزامن افتتاحه مع آخر تشكيلة قدمها، مما جعلنا في سباق مع الزمن».
المعرض المقبل الذي تعمل عليه حاليا سيكون عن البليجكي دريز فان نوتن، رائد المدرسة البلجيكية للتصميم، في بداية شهر مارس (آذار) المقبل.
يعود اختياره، كما تقول، إلى بروز الموجة البلجيكية واجتياحها فرنسا، والموضة عموما، في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي، ولا تزال تأثيراتها سارية.
«منذ زمن وأنا أفكر في معرض خاص بالمدرسة البلجيكية للتصميم، لأنها لا تخاطب العامة، بحكم أن مصمميها متحفظون لا يحبون الأضواء، كما أن أسلوبهم خاص جدا لا يفهمه الجميع. ويعد دريز فان نوتن أهم واحد من هؤلاء المصممين، فهو لا يزال نشطا ويحترمه الجميع في كل أنحاء العالم».
وبالفعل، قابلت دريز فان نوتن في المعهد الفرنسي حيث تلقى محاضرات عن الموضة بنيويورك في عام 2012، وتجاذبا أطراف الحديث.
لفتها شغفه بالأقمشة المختلفة وكيف يتعامل معها في التصميم، «فـ 95 في المائة من الأقمشة التي يستعملها مصنوعة خصيصا له.
كانت هذه نقطة مشتركة بيننا، فالمتحف أيضا يمتلك مجموعة مدهشة من المنسوجات، لهذا اقترحت عليه تنظيم المعرض».
الفكرة كانت صغيرة، لكنها سرعان ما تطورت لتتحول إلى مشروع كبير، سيضم تصاميمه الحالية، فضلا عن قطع أيقونية تسلط الضوء على تأثره بالفن وكيف يترجمه في أزيائه بأشكال أو طبعات لافتة، بعضها سيوفره المصمم من أرشيفه أو من زبائن خاصين، والبعض الآخر جرت استعارته من متاحف أخرى مثل «بومبيدو» و«دورسي» والمتحف الملكي بأنتوورب.
الملاحظ أن باميلا غولبين، بحيويتها ونظرتها الشبابية، لم تضخ دما جديدا على هذه المعارض أو تخرجها من نخبويتها التقليدية فحسب، بل استقطبت لها أيضا شريحة الشباب، بعد أن خلصتها من إدمان الماضي ومصممين غيبهم الموت، وفتحت الأبواب على مصراعيها أمام مصممين شباب. واحد من هؤلاء، المصمم السابق لـ«بالنسياجا» نيكولا غيسكيير، الذي لم يكون بعد إرثا غنيا خاصا به، لكنه بالنسبة لباميلا غولبين كان مهما: «لأن إرثه هو (كريستوبال بالنسياجا)، الذي لم يسبق أن نظم له أي معرض خاص في باريس من قبل، مما دفعني لتصحيح الوضع، وهكذا جاء معرض (بالنسياجا - باريس). نيكولا غيسكيير جزء من هذا التاريخ، لأنه غير صورة الدار وأعاد لها بريقها، لهذا عملت معه على اختيار قطع أساسية كان الهدف منها إلقاء تحية على المؤسس كريستوبال، وهو ما لم يكن سيتحقق من دون مساعدته».
تعترف بأن هذا الأخير لم يكن متحمسا للأمر في البداية، من منطلق قناعته بأن المصمم يجب أن يدخل المتاحف بعد الممات، إلى أن أقنعته بأن مهمتها تتلخص في تحديد بصمة الدار الوراثية، والبحث عن الفروقات والقواسم المشتركة بينه وبين المؤسس، وتقديمها بأسلوب يحفز خيال الزائر ويجعله يفكر.
أكدت له كذلك، أنها تريد أن تنظر إلى الماضي بعيون الحاضر والمستقبل وليس كتاريخ، أو بالأحرى أن يقتصر الاهتمام به على تأثيراته الممتدة إلى الآن.
«كان من السهل أن نطلب من نيكولا غيسكيير التعاون معنا على معرض خاص بكريستوبال بالنسياجا بالكامل، يتتبع مسيرة هذا الأخير من 1937، العام الذي أسس فيه الدار، إلى 1968 العام الذي أغلقها فيه، لكننا أردنا تحديا مختلفا نفاجئ به الزوار، ويحكي قصة الجيل الجديد من المصممين ودورهم في إحياء بيوت قديمة. وطبعا، ليس هناك أفضل من نيكولا يجسد هذا النجاح.. فقد عمل في دار (بالنسياجا) لـ 15 سنة».
الاحتفال بالمصممين وهم أحياء، كما تقول، عملية «أشبه بمداولة أو نقاش لا ينتهي، يتغلغل أحيانا في الشخصي، لما يتطلبه من دراسة وبحث في الصحف القديمة وكل ما كتب عن المصمم وحياته من بدايته إلى الآن، إضافة إلى أني لا أتوقف عن السؤال والتحقيق، مما يجعل وظيفتي أشبه بوظيفة شرطي سري أو صحافي ميداني، يجري لقاءات كثيرة حتى يتوصل إلى حقائق أساسية، يمكنه من خلالها أن ينسج قصة قوية ومؤثرة».
طوال فترة البحث يتخلل علاقتها بالمصمم الكثير من الشد والجذب، فأحيانا تلوح لها فجأة فكرة أو زاوية معينة، تقترحها على المصمم لتتأكد منه أنها تعكس رؤيته الحقيقية، فيكون رده أنه يؤمن بها، ويستشعرها كجزء لا يتجزأ من بصمته، لكنه لم يتوقف عندها أو يفكر فيها بشكل ملموس من قبل.
حينها فقط، تعرف أنها وضعت يدها على الخيط الذي ستنطلق منه، فتبدأ بكتابة السيناريو والتفاصيل، بما في ذلك الإخراج، الذي تحرص على أن يكون مثيرا للنظر والحواس حتى يشد الزوار.
هذه هي فلسفتها منذ 20 سنة، وتستدرك بسرعة معلقة: «لا أصدق أن 20 سنة مرت بسرعة البرق، وهو أمر انتبهت إليه منذ أيام فقط عندما قالت لي زميلة التحقت بالعمل أخيرا إنها تتعجب أني أعمل في المتحف منذ عام 1993! لا أنكر أنني تفاجأت أني بقيت في العمل نفسه طوال هذه السنوات، لكني سرعان ما عرفت أن السبب يعود إلى أني لا أفكر فيه كوظيفة، فهو جزء من اهتماماتي الخاصة. في حالتي، هناك خيط رفيع جدا بين الوظيفي والاهتمام الخاص».
ما يجعل هذه الوظيفة ممتعة أنها متجددة، ولا تخلو من المفاجآت التي تتعلم منها وتبقيها متوثبة ومتحفزة، وتستدل على هذا بتجربتها في أبوظبي، من خلال مشروع عن اللؤلؤ. تقول: «بموجب تعاون مع متحف متحف، كنت مطالبة بتنظيم مجموعة من النقاشات والمؤتمرات حول اللؤلؤ من القرن الخامس عشر وعلاقته بالموضة حاليا، وما له من تأثيرات اقتصادية وسياسية أيضا».
ما زاد من عنصر الإثارة أن منطقة الشرق الأوسط عموما كانت تعيش انتعاشا كبيرا في المجالات الفنية، «وكانت أبوظبي، على وجه الخصوص، تشهد تحولات مهمة، مما جعل التجربة مذهلة بالنسبة لي. كان كل من تحدثت معهم متفتحين بشكل كبير ومستعدين لتبادل الآراء ووجهات النظر. كانت كل المحادثات غنية وملهمة، خصوصا أنهم يعرفون تماما ما يريدون. يدركون تماما أن المشاريع الكبيرة تحتاج إلى رؤية بعيدة المدى قد يصعب تقبلها بسهولة، لأن الناس لا تريد أعمالا ثورية بقدر ما تريدها جديدة وسهلة، لكن التجارب تؤكد أن الثوري والجديد يتحولان مع الوقت إلى عادي ومقبول، وهذا ما أتمنى أن يحدث في الشرق الأوسط. المهم هنا هو تحقيق الموازنة بين الممكن وإلى أي مدى يمكن الدفع بهذا الممكن».